المسرح اليونانى القديم
مصدرة و ميلادة
أن الدراما اليونانية هى خلق شعرى مركب يهدف الى رفع المستوى الفكرى للمتفرج ، فلم تكن الدراما عبارة عن جملة
أو وسيلة فقط للتعبير ولكن مشاهد مسرحية متكاملة تقدم أحداث قوية يتفاعل معها المتفرجين مع الممثلين على خشبة المسرح ليكونوا معا دراما حقيقية و سيمفونية
وتنحدر الدراما من مواقف و أحداث من الاساطير الدينية القديمة
وبذلك ارتبط ظهورها فى البدايه بحفل يقام سنويا على شرف آله
الخمر( ذ يونيسوس ) ، وكانت تلك الحفلات لها أهمية كبرى فى
المجتمع الاثينى القديم ، حيث يتوافد المؤيدون و المشجعون
والعاشقون للآلهة بأعداد كبيرة و بشعور بالبهجة ، وكان الهدف
النهائى هو الوصول الى حالة النشوى و اللذة و المتعة
ومن هنا بدأت الدراما عام – خمسمائة و ثلاثة واربعين قبل الميلاد- فى منطقة ذيونيسوس ( أكروبوليوس ) ، حيث تطورت
الدراما كنتيجة حتمية لتواجدها داخل المجتمع الاثينى المتطور
تتكون الدراما من أشكال ثلاثة :-
أولا :- التراجيديا
ثانيا :- الكوميديا
ثالثا :- السخرية الدراميا
وقد حدثنا الفيلسوف العظيم ارسطو ( أن التراجيديا هى تقليد
لحالة مهمة وجادة و أعادة للوقائع التى حدثت فى الماضى )
و أن كانت غير مشروطة بتمثيل الواقع حرفيا ، ولكن بطريقة
وبأداة حرة و منفعية .
# ومن أهم أشكال التراجيديا ( هو العمل المسرحى ) وهدفة هو
أعداد المتفرج و قيادتة الى طريق مملوء بالاحاسيس و المشاعر
و الخوف والرهبة و المتعة و اللذة ، بهدف تفاعل المتفرج
فى الحضور المسرحى عاطفيا و منطقيا ، وبذلك يشترك المتفرج ويتعاطف مع الحدث ، وأن كان يختلف مع مواقف القدر .
# ومفهوم ومعنى كلمة النشوى فى الفكر المسرحى اليونانى هو
الوصول بالمتفرج من خلال العمل الفنى المسرحى الى هدوء البال
والشعور بالراحة النفسية والتأكد من النصر فى النهاية .
و أن مسألة النصر لبطل الرواية هو موقف أخلاقى أو أعادة
الأوضاع على نصابها الاخلاقى ، وبالتالى فأن المتفرج يستطيع الوصول الى الخلاص و يرتقى الى المستوى الفكرى العالى
و التفاعل مع الحالاتالأنسانيه المرتفعة
العظماء الثلاثاء
فى الفكر المسرحى اليونانى القديم
اسخيلوس

أقدم مؤلف مسرحى يونانى فى العصر القديم ( خمسمائة و خمسة و عشرين قبل الميلاد ).
ولد فى الف سينا ، وأنحدر من أسرة اروستقراطية ، حيث تلقى التعليم
العالى ، وكانت هوايتة الكتابات المسرحية ، حيث حصل على أول جائزة
فى المباريات التى كانت تقام فى المسرح الاغريقى القديم عام ( ربعمائة
و اربعة و ثمانين قبل الميلاد )وأن لم تكن الجائزة الوحيدة فى حياة
اسخيلوس ، بل حصل على ثلاثة عشرة جائزة اخرى بعد ذلك .
# وتمتاز أعمال اسخيلوس فى التأليف المسرحى بعدة عوامل أهمها :-
أولا :- شعور المتفرج بأهمية وقيمة الحياة عند الانسان من خلال النص
المسرحى .
ثانيا :- مواجهة المؤلف بقوة وأقتدار لفكرة الحياة والموت .
ثالثا :- البقاء الانسانى يجب أن يكون فى حدود وسطيه ، كما أن البشر
يجب أن يحترصوا من الشكل الانتقامى المتواجد فى بعض عناصر البشر بل وبعض الآلهة.
رابعا :- الانسان فى تراجيديا اسخيلوس ليس فرد ، ولكن عنصر مهم فى المجتمع الانسانى ، وكذلك فى مجتمع الآلهة ، بل وعنصر متواجد بقوة فى الطبيعة .
# ومن هنا نستخلص أن اسخيلوس هو المؤسس الاول للتراجيديا
والمسرح اليونانى #
والجدير بالذكر أن اسخيلوس كان يشترك بنفسة فى التمثيل أثناء المسرحية ، وذلك فى عدة صور و أشكال متعددة ، فأحيانا يكون
ناقد – أو راوى – أو عضو فى المجموعة – أو فى الكورال .
أن أعمال اسخيلوس تعتبر الاساس الاول و الدعامة الاولى التى قام
عليها المسرح اليونانى ، بل و مازالت أعمالة حتى الآن تدرس .
أهم أعمال اسخيلوس
# اولا :- الفرس .
# ثانيا :- السبعة ضد طيبة .
# ثالثا :- المستجيرات .
ثم الثلاثية المشهورة وهى :-
*** اجامنون
*** حاملات القرابين
*** الصافحات
وفى عام ( ربعمائة و خمسة وعشرين قبل الميلاد ) خسر اسخيلوس
أول جائزة له مع خصمة سوفوكليس .
مما أدى الى هجرته الى صقلية ( بيلا ) حيث مات هناك فى عام
( مائتين و ستة وخمسين قبل الميلاد ) ، وترك لنا تاريخ مسرحى عظيم
على مدى الاجيال .
سوفوكليس

ولد عام ( ربعمائة و سبعة وتسعين قبل الميلاد ) من أسرة أرستقراطيه
فى كولونوا خارج العاصمة اثينا .
من أقدم المؤلفين للمسرح اليونانى القديم ، ويذكر لنا التاريخ :
أن أول محاولة لة لدخول مباريات المسرح اليونانى حقق انتصار على
اسخيلوس ، كان محبا لوطنة و لبلدتة .
حصل على عديد من الاوسمة بالرغم أنة رفض دعوات كثيرة من الملوك
للعمل كمستشار ، وكمساعد للقائد اليونانى العظيم ( بركليس ) .
أحب مدينتة ، ومات فى مدينتة عام ( ربعمائة وستة قبل الميلاد )
عن عمر يناهز تسعين عام .
# أن شخصية سوفوكليس عديدة الاوجة و الملامح .
حيث يجد الانسان صعوبة بالغة فى فهمها .
فكان رجلا يحترم الآلهةولكن بدون أدنى تعقيدات بشرية ، ولذلك قدم
من خلال أعمالة دور الآلهة وقدرتها على التحكم و التصرف فى مقدرات
الانسان ، وفى نفس الوقت كان ينادى بأن الانسان يجب أن يكون حرا
لكى يحدد أعمالة ، و أخطائة ، و أختياراتة بنفسة
وفى نفس الوقت على الانسان أن يكون مستعدا لمواجهة النتيجة
مهما كانت .
وبالتالى فأن سوفوكليس كان حساسا دقيقا أمام المشاعر الانسانية .
وهذا يظهر من خلال أعمالة و أبطال مسرحياتة الذين فجروا
افربيدس

## ولد افربيدس ( عام ربعمائة وثمانين قبل الميلاد ) فى ( سلامينا )
من أسرة ارستقراطية، وكان يمتلك عن أسرتة مكتبة كبيرة .
## ظهر كمؤلف للمسرح اليونانى القديم فى وقت عصيب أثناء التحديات
الكبيرة للمؤلفين المسرحيين .
حيث توفى اسخيلوس فى ذلك الوقت بعد نجاح كبير ، وعلى مدى خمسة
واربعين عاما ، وكان سوفوكليس. متواجدعلى المسرح اليونانى القديم و على مدى عشر سنوات بنجاح كبير فى مواجهة مؤلفين
آخرين فى مجال المسرح ، ومن هذا المنطلق فأن الوقت كان عصيبا لافربيدس بصفته شابا يواجه تحديات كبيرة من مؤلفين عظام
، بل وعصر ملىء بالعمالقه فى المجال المسرحى .
ولم يسعى افربيدس فى كسب مكان له وسط هؤلاء العمالقه من رجال المسرح : # اسخيلوس - ## سوفوكليس
ولكنه أختار طريق آخر ، و فكر أخر ، أعاد للمسرح الاغريقى شبابه و حيويته ، وأصبح ظاهرة جديدة أمام المتحفظين من عظام المسرح .
الا أنه أستطاع أن يحصل على جائزة المسرح مرة واحدة فقط .
ويذكر التاريخ لنا أن بعد وفاته أصبحت أعماله من أهم الاعمال المسرحيه اليونانيه الشهيره و التى لاقت حب الجماهير ، بل تدفق
مسرح افربيدس الى مساحه واسعه خارج اليونان ، بحيث غطى مساحه شاسعه فى أوروبا .
كان افربيدس فريد فى فكره ، حيث حلل الطبيعه الانسانيه و المشاعر
الداخليه ورغبتها و أهدافها و محركاتها عند الانسان .
وحاول أن يضع الحقيقه واضحه ويستخدم فى نفس الوقت عنصر
الشك مع التعليق والتساؤلات عن أى شىء و كل شىء دون أن يغلق
الباب أبدا حول امكانية خطأ الآلهه .
فكان قمه ثالثه من قمم المسرح الاقريقى القديم .
أهم أعمال افربيدس
# اليكترا
# ايفجينيا
# طرواده
## هيلين
## ميديا
و من هنا نستخلص الملامح النهائيه لاعظم الكتاب المسرحيين فى تاريخ
الفكر المسرحى اليونانى القديم ، من حيث الطبيعه و الاسلوب والشكل .
وبالتالى نستطيع القول أن :
اسخيلوس هو المؤسس الاول للدراما اليونانيه ، وأن اعماله تعتمد على
أسلوب واحد ، برغم رؤيته لفكرة العداله الآلهيه .
اما بالنسبه :
لسوفكليس قد قدم على المسرح البعد الانسانى للفرد ، وقدرته على
أن يكون متحكما و قادرا على مواجهة قدره
وأخيرا نأتى الى :
افربيدس الذى أستطاع و بكفائه وقدره أن يحلل الطبيعه الانسانيه من
خلال الواقع الحقيقى للانسان دون تحدى للآلهه .
أساس الفكر الدرامى عند المسرح اليونانى القديم
تعتمد التراجيديا القديمه اليونانيه على عاملين :
العامل الاول : الاسطوره
العامل الثانى : اللغه
بالنسبه للاسطوره فقد أحتوت عل كل عناصر التراث اليونانى
القديم والاحداث القديمه .
أن الاسطوره تعتبر عامل مهم ومسيطر فى يد المؤلف الدرامى ،
بل انه يعتبر شىء مقدس فى الهيكله التراجيديه .
وبالنسبه للعامل الثانى وهو اللغه ،فهو عامل قوى وفعال لاهمية الكلمه
وقدرة اللغه على اعطاء ابعاد غنيه وثريه للتعبير عما يجول فى شعور المؤلف الشاعر .
وبالتالى فأن اللغه هى شىء مقدس فى البناء الاساسى التراجيدى .
الاسطوره
أصبحت الاسطوره شىء اساسى فى الفكر الايدولوجى بحيث دخلت
الاسطوره مع الحدث من خلال العادات و التقاليد للمجتمع اليونانى
القديم ، وبالتالى فأن الاسطوره أصبحت شىء مقدس وواقعى للتراجيديا
و تتمتع الاسطوره بعدة عناصر أهمها :
# شرح الملامح الهوميريه .
# الاحداث و الاساطير التى كانت تدور خلف الابواب فى القصور الملكيه فى ( طيبه – كريت _ ارجوس )
من أهم الاساطير التى وجدت نفسها على المسرح بأقتدار هى أسطورة
( ديمترا وابنتها بيرسيفونى ، وكذلك رب الارباب ثيوس أو ذياس ،
أسطورة ذيونيسوس وابوللون ) .
كل هذه الاساطير كانت اساسا قويا فى الفكر اليونانى القديم ، بحيث اعتمدت على مصادر مثل : اسطورة هيراقل _ و اسطورة طرواده
القبرصيه الدانائيه الاثيوبيه _ واسطورة برومثياس .
اللغه
أن العامل الثانى كان اللغه بكل فحواها وقوتها من عمق الكلمات ،
وقدرة هذه اللغه على تهيئة المناخ و اثراء العمل المسرحى والشعرى .
وبالتالى فأن العامل الثانى هو عامل مقدس للتراجيديا و الفكر اليونانى القديم .
وكانت اللغه اليونانيه القديمه مكونه من سبعة وثمانين علامه على
الحروف المتحركه والساكنه ، أى ما يشبه بنظام الاختزال ، وظلت
على ذلك حتى تبنت اليونانيه الحروف الفينيقيه .
لقد طورها اليونانيون حتى أصبحت على هذا النحو لغه قابله للحديث
وكان ذلك قبل القرن الثامن فى تقديرنا .
وبالتالى فأن ملامح هوميروس كانت المصدر اللغوى الاول والاساسى .
ومن هنا جاء الطاغى الاثينى ( بيستراتوس ) وقدم النظام الرابسودى
أو الرابسوديه ، مع أستخدام الفلاوتو _ القيثاره _ و أستخدام العصا .
و الجدير بالذكر أن هناك ظواهر تؤكد على وجود نصوص يونانيه
قديمه ، وكذلك نصوص أدبيه منذ فترة الف و ستمائه قبل الميلاد
حتى الف و مائتين قبل الميلاد، وقد كتبت هذه النصوص بلغة أكتشفت
موجوده على أوانى فخاريه فى معبد ( كنوسوس ) .
كما أن اليونانين القدماء قد أعتمدوا فى أغانيهم و أشعارهم على
ما يسمى : _
# استروفا ( الدوران أو اللف )
## اندستروفا ( الدوران المعاكس )
### ابوذوسى ( المضاده )
وقد ظهر هذا واضحا فى أشعار ( سيميونيدى و بينداروس ) .
وبرغم أن سيميونيدى كان أكثر شهره وخصوصا فى مجال الشعر عن
بينداروس ، الا أن بينداروس قد ظل فى عبق التاريخ ، حيث تعدى
شعره خارج الحدود اليونانيه ، ووصل الى روما و الاسكندريه وقبرص
أن الشاعر اليونانى القديم بينداروس من مواليد ثيفا ( طيبه ) عام
خمسمائه و اثنين وعشرين قبل الميلاد ، وينحدر من أسره أرستقراطيه
من محافظة ( فيوتيا ) وتعلم الشعر والادب فى أثينا ، وظل محافظا على
عادات و تقاليد الآله ( أبوللو ) .
أن شعر بينداروس يعتبر حلقة وصل بين الفكر المسرحى اليونانى
القديم والشعر اليونانى مع العالم الخارجى ، وبالتالى فلقد تم الاعتراف
به على انه أعظم الشعراء اليونانين فى كل العصور ،
حيث يتبين لنا من شعره الجمال مع الرقه و العذوبه بجانب الضعف
الانسانى أمام قوة المجد و الآلهه .
عالمية المسرح اليونانى القديم
أن المسرح والادب اليونانى أخذ طابع الاستقرار منذ انشاء المكتبات
الاولى فى أثينا ، بحيث أصبح لهذه المكتبات رواد من القراء ، ويذكر
التاريخ أن الطاغيه الاثينى ( بيستراتوس ) هو أول من أسس مكتبه
فى أثينا .
ثم جاء من بعده ( بوليقراطوس ) جيث انشأ أول مخزن لتجارة الكتب المسرحيه فى جزيرة ( سامو ) و على هذا النحو ظهرت مكتبات كثيره
أخرى ، و أنتشرت فى عصر ( أفلاطون _ أرسطو تيلوس ) وبعد فتره
ظهرت أعمال المسرح اليونانى القديم فى مدينة الاسكندريه و روما و صقليه و قبرص . وان كانت الاسكندريه تأخذ طابع خاص ، وذلك من
خلال مكتبة الاسكندريه التى جمعت كل أعمال الفكر اليونانى القديم حتى
عصر الملكه كليوباترا آخر ملكه مقدونيه ( خمسين سنه قبل الميلاد ) .
وبعد دخول الرومان الى الاسكندريه ، ظهر المسرح اليونانى القديم بقوه فى أوروبا وذلك من خلال أكبر مركز حضارى فى ذلك العصر وهو
( مكتبة الاسكندريه ) ، وبالتالى أعطى الحضاره الى المجتمع الاوروبى .
وأدى فى النهايه الى ظهور عصر الميلاد ، ثم عصر النهضه .
أن الادب الاوروبى و المسرح الاوروبى قد اعتمدا اعتمادا كليا على
مصدرين :_
أولا :_ المصدر الكلاسيكى اليونانى و المسرح اليونانى القديم .
ثانيا :_ المصدر الثانى : أن ترجمة ( الالياذه _ و الاوديسا ) الى اللغات الانجليزيه و الفرنسيه و الالمانيه أعطوا دفعة قوية لبناء المسرح
الكوميدى الفرنسى ، بل ظهر فى الجامعات الاوروبيه مثل كمبردج -
وأكسفورد و لا ننكر أن أشعار بينداروس كانت تهزم بقوه أشعار شكسبير .
أن المسرح الاوروبى قدم( الانثروبومورفيزم ) بمعنى تصدي
الآله كما لو كان بشر على خشبة المسرح .
أن الحقيقه التاريخيه التى تؤكد أن الثقافه اليونانيه و الفكر المسرحى
القديم هم الاصل للحضاره و الثقافه الاوروبيه .
فأننا نستطيع القول أن المسرح اليونانى القديم هو ثقافه انسانيه وعلميه.
و أيضا عالميه
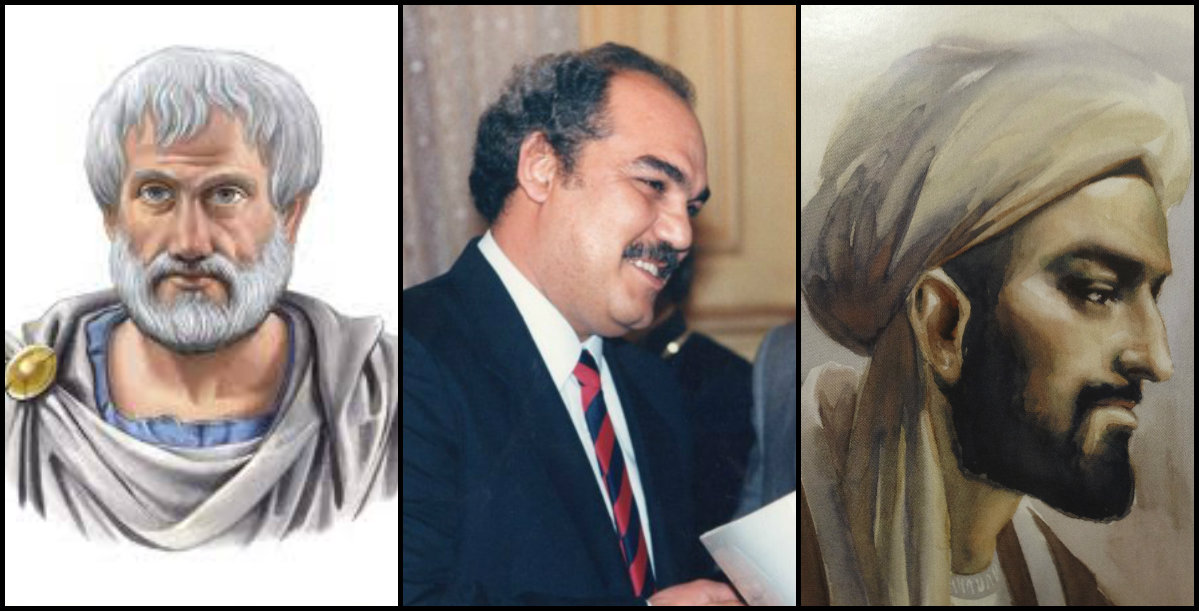









.jpg)


.jpg)


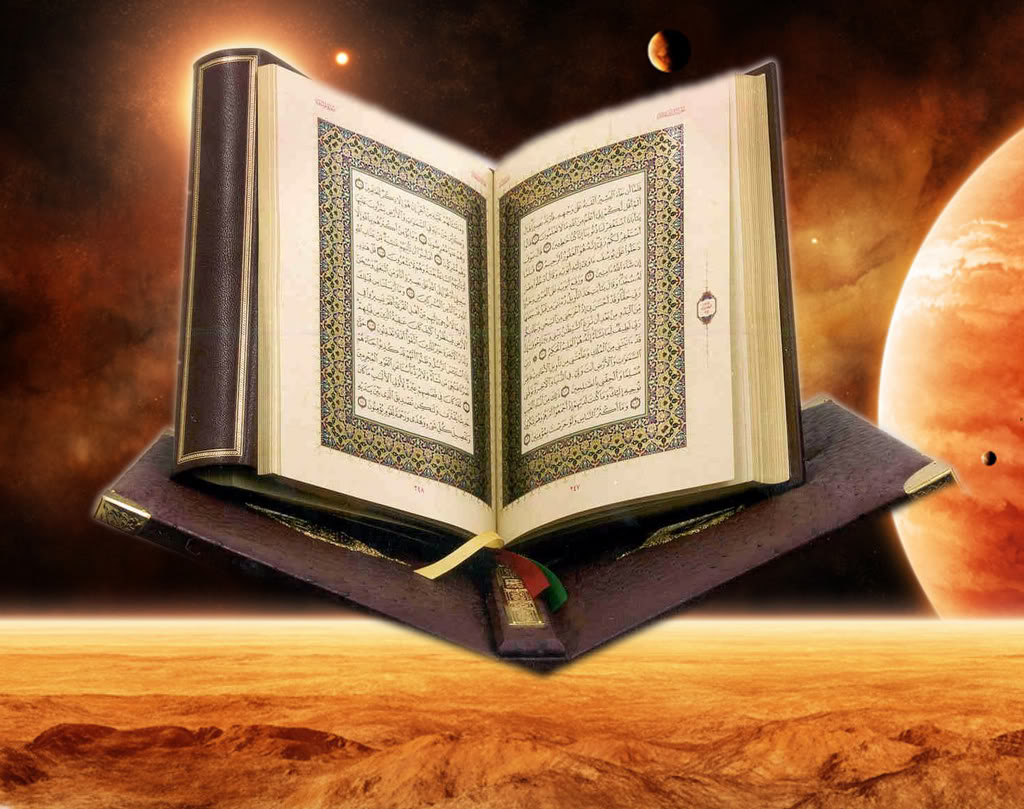

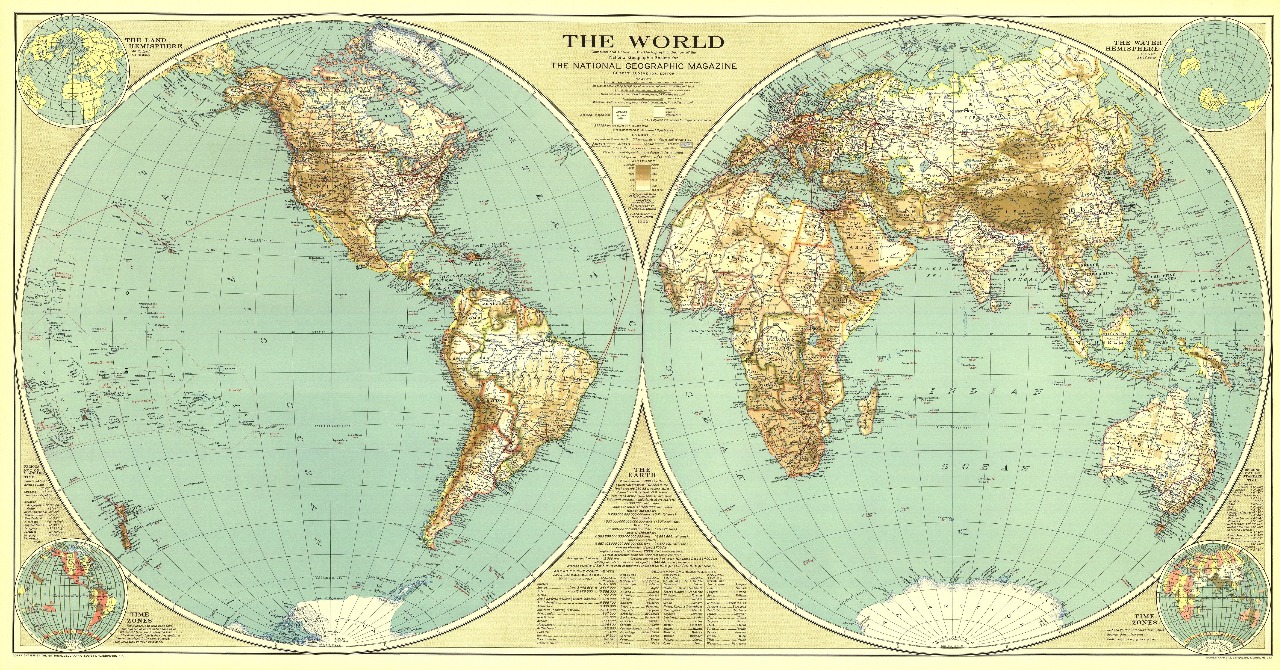
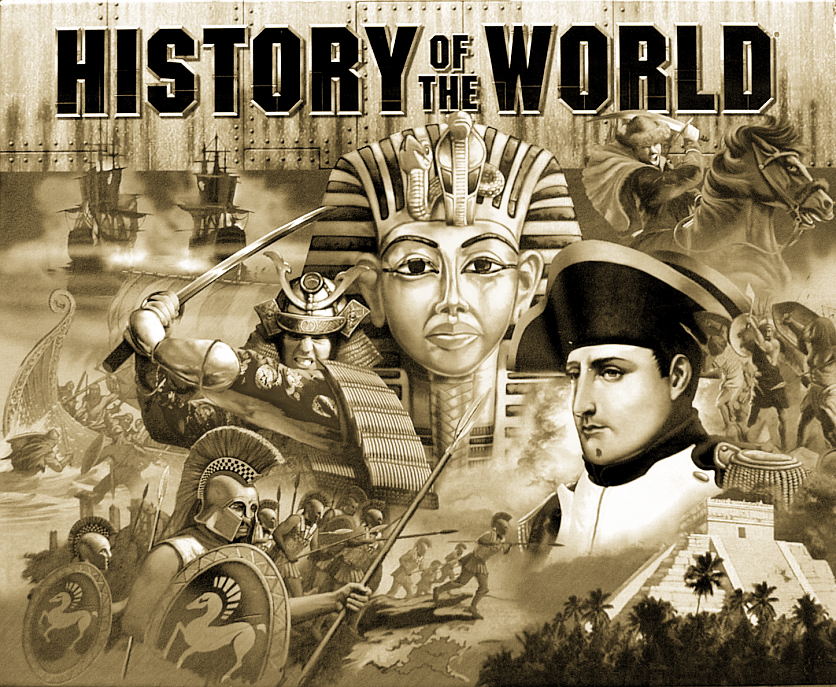
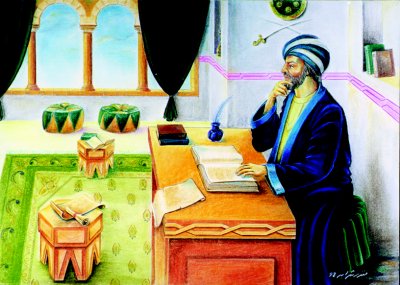
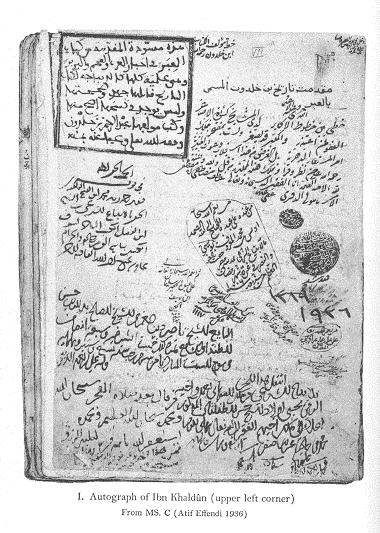


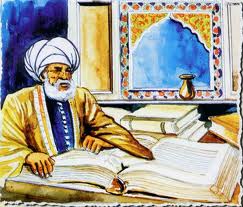
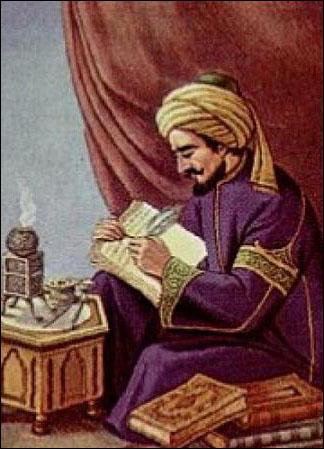





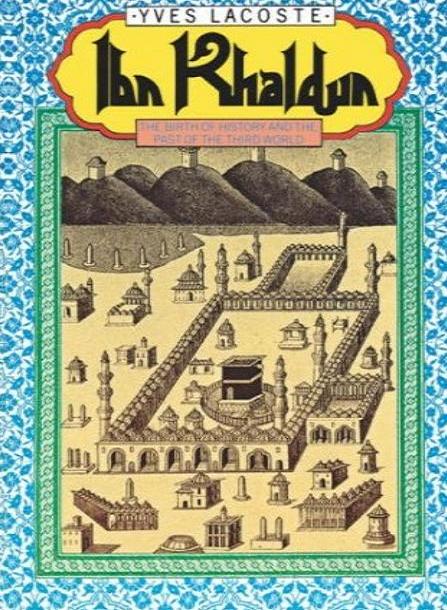
.jpg)